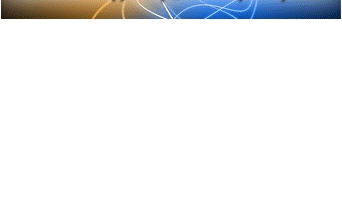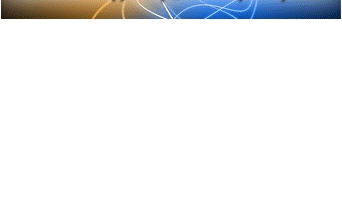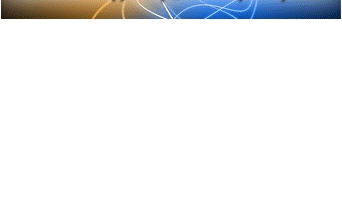كانت مجرد زيارة لرؤية الأهل، هي تلك التي حالت بيننا وبين ألأرض والأهل والتراب المقدس. فالعدو أوصد الأبواب في وجه أصحابها. فقدر لعائلة كما الحال لآلاف العائلات، أن تقطع شرايين حياتها، وأن تقلع من جذورها، وأن تنجلي عن ذكرياتها، وأرض ميلادها وأجدادها. فضاع كل شيء، ضاع الوطن، ضاع الأهل، ضاع المال، ضاع البيت، ضاع الدفء، ضاع الحب، وضاعت الجذور.
احتضننا وطن جميل، ودفء شعب طيب، فلم نشعر بالغربة، ولكن، يبقى الحنين لشمس القدس متقدا، وتظل الأعين نحو شعاع النور ومهبط الأنبياء محلقة، وتبقى الأفئدة لدوس الترب الطاهر متلهفة. فلزهرة المدائن طابعها الخاص، الذي يفجر في القلوب دفئا يسري في العروق، ويخطف الأبصار بأشعة تبهر الأنظار.
حلت النكسة، وتلونت الحياة بحالك سوادها، وبكى الجميع القدس، وشحنت القلوب العربية بالحزن والأسى. لقد طعنت الأمة في صميم قلبها، فنزفت دماء الحرقة والمر، ولبست الدنيا ثوب الحداد على طريحة الغدر والبطش. ولكن بالرغم من الوشاح الأسود الذي توشحت به الأمة المنكوبة، إلا أن الأمل كان ما يزال يبعث أشعة، لبعث الحياة في قلوب أماتتها الأحزان.
كانت الحياة ما زالت تنبض بالحب والعطف والأمل. فعام النكسة كان أفضل بكثير من أعوام النكسات التي نعيشها الآن، والتي خلت من نبضات الحب والأمل والكرامة، والتي حولتنا لآلات متحركة تفتقد المشاعر والأحاسيس.
وفي تلك الأثناء كان أفراد الأمة العربية دون استثناء، يتجمعون حول ذلك المذياع "صوت الأمل" الذي لم يخل بيت منه في ذلك الوقت. وكان أبي الفاضل كغيره من أبناء العروبة ،يحتضن ذلك الصندوق الخشبي الذي بالرغم من كبر حجمه، إلا أنه كان لا يجود علينا بأكثر من محطة أو اثنتين، ومهما حاولنا عبثا تغيير اتجاهه أو مكانه أو العبث بأزراره المحدودة، التي تتمثل بزر لخفض ورفع الصوت، وآخر للبحث عن تلك المحطات المحدودة لسماع تلك الخطابات الباعثة على الأمل، ولنسمع ما كنا نتلهف لسماعه " غدا سنعود" تلك الجملة ذات الوقع السحري على أسماعنا. "غدا سنعود" إنتظرنا... وإنتظرنا... آملين بأن يحين موعد مجيء ذلك الغد المنتظر، لنجمع حقائبنا وأمتعتنا التي لا تحوي أكثر من المستلزمات القصوى لحاجاتنا، لنعود لأرض التين والزيتون، وحكايات الجد والجدة، ودفئ شمس القدس، ومسجد الأقصى الشريف. لكن انتظار الغد طال، ولم نعرف المدى الزمني لذلك الغد الموعود، هل هو يوم أم شهر أم عام أم قرن أم قرون..؟؟
لم أكن أعي تماما ما كان يدور في تلك الأثناء لصغر سني، ولكني ما أزال أذكر ملامح والدي العزيز والأمل يرتسم على وجهه وهو يستمع إلى خطابات الأمل، وأغاني الحماسة لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم.
كانت الأيام جميلة، وكل شيء كان له وقعه الخاص، كانت القلوب مفعمة بالعطف والحب والترابط، وكانت العائلة متماسكة بحبل التواصل والتعاون والمحبة، بالرغم من الحياة البسيطة التي كانت تغلب على معظم أبناء الأمة العربية. لقد كان الأمل بغد مشرق، وعيش بكرامة هو هاجس كل فرد.
كنت كأبي، أنتظر ذلك الغد الذي فيه سوف نعود، لينجلي عن ناظري ذلك الحزن الذي كان يخيم على ملامح أبي، حينما كان يقف أمام صورة والديه، ليحملها ويقبلها، محاولا اخفاء دموعه عبثا عن أعيننا.
مرت الأيام، وتحول المذياع الخشبي باعث صوت الأمل إلى صوت وصورة، وما زال أبناء الأمة العربية ينتظرون ذلك الحدث الجلل، ينتظرون ذلك الغد الذي فيه سوف نعود، ولكن مرت الأيام، ومرت الأعوام ولم يأت ذلك الغد الذي فيه سوف نعود، فمات أبي، ومات جدي، وماتت جدتي، رحمهم الله أجمعين وما زلنا ننتظر ذلك الغد البعيد، الذي فيه سوف نعود.
لن أذرف دموعي المحبوسة حزنا، أملا مني، بأن تذرف فرحا، حينما يأتي ذلك الغد الذي فيه سوف نعود، حينما نستعيد كرامتنا المسلوبه، ونصحو من سبات نومنا الطويل، فمئات الملايين من أمتنا الغراء، لا بد وأن تجود بالكثيرين ممن تعلو جباههم العزيمة والحماس للذود عن أمة تلتقط أنفاسها الأخيرة. فإلى اللقاء في ذلك الغد... الذي نرجو من الله أن لا يطول، وأن يأتي في ألقريب العاجل إن شاءالله.